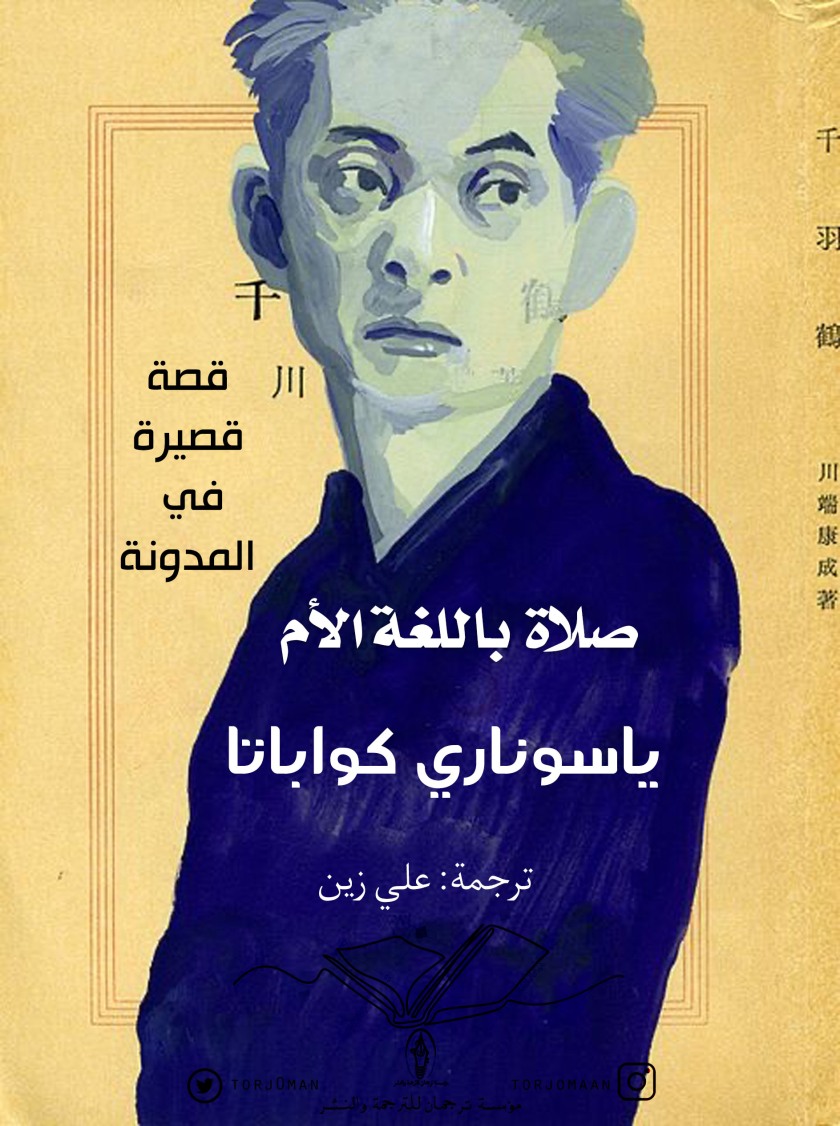التخلي عن قطة
ترجمة يحيى الشيخ
بالطبع لدي الكثير من الذكريات لأبي . إنه من الطبيعي فحسب، بحيث نأخذ بعين الإعتبار بأننا عشنا تحت نفس السقف لمنزلنا والذي لم يكن فسيحاً من وقت ولادتي إلى حين مغادرتي للمنزل بسن ثمانية عشر عاماً. وكما هي حالة أغلبية الأطفال والأباء، أتخيل ، بعض ذكرياتي عن أبي بأنها كانت سعيدة ، وبعضها ليس بقدر كافي. ولكن تبقى تلك الذكريات معظمها عالقة في الذهن بشكل واضح ولا تندرج حالياً تحت أي فئة ; إذ تنطوي على كثير من الأحداث العادية .
على سبيل المثال :
عندما كنا نعيش في شوكوغاوا ( جزء من مدينة نشينوميا، بولاية هايوغو) ، ذهبنا في يوم ما إلى الشاطئ للتخلص من قطة. ليست قطة صغيرة ولكنها أنثى قط أكبر سناً. لماذا احتجنا إلى التخلص من القطة لم أستطع أن أتذكر ذلك. كان المنزل الذي عشنا فيه بيت عائلي مع حديقة و مساحة كبيرة للقطة. ربما كانت قطة ضالة وقد أخذناها و هي حامل، شعر أبواي بأنهم ليس بوسعهم الإهتمام بها مرة أخرى. ذاكرتي يشوبها شائبة في هذه النقطة . كان التخلص من القطة في ذلك الوقت رغبة مشتركة، وليس شيئا يرغب أحد ما أن ينتقدك لفعل ذلك. لم تخطر في بال أي شخص ابدأ فكرة إخصاء القطط . كنت في الصفوف الدنيا بالمدرسة الإبتدائية بذلك الوقت، أعتقد، ربما كان حوالي عام 1955، أو لاحقاً بقليل. و كان بالقرب من بيتنا حطام مبنى البنك الذي قد تعرض للقصف بالطائرات الأمريكية—فإنها إحدى ندوب الحرب القليلة التي لا زالت ظاهرة.
انطلقنا أنا وأبي في ظهيرة ذلك الصيف للتخلي عن القطة عند الشاطئ. ضغط على دواسة دراجته، بينما جلست في الخلف حاملاً الصندوق و بداخلها القطة. قدنا على إمتداد نهر شوكوغاوا، وصلنا إلى شاطئ الكوري، وضعنا الصندوق أرضاً حول بعض الأشجار هناك، دون النظر إلى الوراء، وعدنا إلى البيت. لابّد أن يبعد الشاطئ عن بيتنا حوالي كيلو مترين.
عند المنزل ، ترجلنا من الدراجة — نناقش كيف شعرنا بالأسف حيال القطة، ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟— و عندما فتحنا الباب الأمامي كانت القطة التي تخلينا عنها للتو هناك، تقوم بتحيتنا بمواء ودي، و بذيلها الطويل منتصباً . كانت قد سبقتنا إلى المنزل. ففي حياتي، لم أتمكن من معرفة كيف فعلت ذلك. كنا على الدراجة، رغم ذلك. ولقد تعثر أبي كذلك. وقفنا هناك للبرهة، دون أن ننبس ببنت شفة. ببطء، تغير منظر أبي من ذهول تام إلى نظرة إعجاب و في النهاية ، و بتعبيرٍ عن ارتياح. عادت القطة كي تكون حيواننا الأليف.
كان لدينا قطط دوماً بالمنزل، وكنا نحبهم. و لم يكن لدي أخوة وأخوات، كانت القطط والكتب أفضل أصدقائي حين كنت أشب عن الطوق. أحببت أن أجلس على الشرفة مع القطة متشمساً بنفسي. لذا لماذا أخذنا القطة إلى الشاطئ وتخلينا عنها؟ لماذا لم أحتج على ذلك؟ تلك الأسئلة—بالإضافة إلى كيف سبقتنا القطة إلى المنزل — لم تزل بلا إجابة.
ثمّة ذكرى أخرى لوالدي هي :
يجلس كل صباح ، قبل تناول الإفطار ، لفترة طويلة أمام ضريح بتسودان في منزلنا، يتلو باهتمام مغمض العينين الصلوات البوذية،. فلم يكن ضريحاً بوذياً عادياً، تماماً، ولكن كان عبارة عن صندوق اسطواني زجاجي صغير بها تمثال بوديساتفا منقوش بشكل جميل داخله. لماذا يتلو والدي سوترا كل صباح أمام الصندوق الزجاجي، عوضاً عن التلاوة أمام بوتسودان الأساسي؟ هذه واحدة من أسئلة عديدة في قائمة أسئلتي لم ترد لها إجابة .
على أي حال، كان جلياً أن هذه شعيرة مهمة بالنسبة له، أشار أحدهم بتلك البداية كل يوم. على حد علمي، لم يفشل أبداً لإداء ما يدعوه ب ‘‘واجبه’’ ولا يسمح لأحد أن يتدخل فيها. كان ثمّة تركيز شديد عن العمل برمته؛ وليست منصفة، وتوسم ببساطة ب‘‘عادة يومية’’ .
ذات مرة ، عندما كنت طفلاً ، سألته لأجل من كنت تصلي، و رد بأن كان ذلك لأولئك الذين قد ماتوا في الحرب. و إلى زميله الجندي الياباني الذي قد مات، لطالما كان الصينيون أعداءهم. لم يُعط المزيد من التفاصيل، ولم أقم بالضغط عليه. أظن لو أن كان لدي رغبة بالتحدث لفتح قلبه لمزيد من التفاصيل. ولكن لم أفعل ذلك. كان ثمة شئ ما في داخلي حال دون أن أسعى وراء الموضوع.
يتعين علي أن أشرح قليلاً عن أصل أبي. كان والده ، بينشكي موراكامي، الذي ولد في عائلة فلاحين في ولاية أيشي. كما هو شائع بين الأبناء الصغار، كان جدي قد أرُسل إلى معبد قريب للتدريب ك كاهن. كان طالباً لائقاً، وبعد فترة من التدريب في معابد عديدة كان قد عيُن كاهناً رئيسياً في معبد أنيوجي، في كيوتو. كان لدى هذا المعبد أربعمائة أو خمسمائة عائلة في أبريشتها، وبالتالي كانت ترقية وظيفية تماماً بالنسبة له.
نشأت في أوساكا– بمنطقة كوبي، وبالتالي لم تكن لدي فرص عديدة لزيارة منزل جدي، بالنسبة لمعبد كيوتو هذا ، لدي ذكرى قليلة عنه. ما فهمته، ومع ذلك ، أنه كان شخصاً حراً وغير مقيد، و معروف عنه حبه للشرب. كما يدل أسمه — يعني صفة بن أول اسمه ‘‘بلاغة’’—كان لديه طريقة مع الكلمات ; كان كاهناً مؤهلاً ، وكان على ما يبدو شعبياً. أتذكره شخصية كاريزمية ، بصوت مدوي .
كان لدى جدي ستة أبناء (ولا فتاة واحدة )، وكان يتمتع بصحة جيدة، ورجلاً محباً، ولكن للأسف، عندما كان في السبعين من عمره ، ففي الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحاً من 25 من أغسطس عام 1958م ، صُدم بقطار بينما كان يعبر مسار القطار طريق كيشين، التي تربط كيوتو (ميساساجي) و أتوزو، و قُتل على أثرها. كانت سكة حديد غير خاضعة للمراقبة، بحيث تقطع في يامادا- تشو،كيتاهانينما،ياماشينا ، في هيقاشيما- كو. ضرب إعصار كبير إقليم كينكي في هذا اليوم بالذات; كان يمطر بغزارة، وكان جدي يحمل مظلة، ربما لم يرى القطار يسير منعطفاً. و كما كان سمعه ضعيفاً أيضاً.
علمت أسرتي مساءاً بأن جدي قد مات، أتذكر أبي يُجهز بسرعة لذهاب إلى كيوتو، و أمي تبكي ، متشبثة به، ملتمسة ‘‘ مهما فعلت، لا توافق على تولي المعبد’’ كنت حينها بسن تسعة سنوات في ذلك الوقت، ولكن حفرت هذه الصورة في دماغي، مثل مشهد لا يُنسى من فيلم باللون الأبيض والأسود. كان وجه أبي بلا تعابير، ويومئ رأسه بصمت. أعتقد أنه اتخذ قراره مسبقاً. بإمكاني أن أشعر بذلك.
ولد أبي في 1 ديسمبر عام 1917م ، في أواتا- غوشي، ساكي- كو، بمدينة كيوتو. عندما كنتُ طفلاً ، كانت فترة ديمقراطية تايشي السلمية تقترب من نهايتها ، اتبعها فترة الكساد العظيم القاتم ، بعدئذ كان مستنقع حرب الصينية اليابانية، و أخيراً ، مأساة الحرب العالمية الثانية. اتى بعد ذلك الإرتباك والفقر مبكراً في الفترة ما بعد الحرب، عندما كان جيل أبي يقاوم من أجل البقاء. كما ذكرت، كان أبي واحداً من ستة أخوة. وكان قد جُند ثلاثة منهم وحاربوا في الحرب الصينية اليابانية، و نجو بأعجوبة دون جروح خطيرة. كان جميع الأبناء الستة تقريباً أكثر أو أقل تأهيلاً كي يكونوا كهنة. كان لديهم هذا النوع من التعليم. أبي، على سبيل المثال، كان كاهناً مبتدءاً، ما يعادل تقريباً رتبة ملازم ثان في الجيش. يحتشد في الصيف، خلال *موسم أوبون النشط—المهرجان السنوي لتكريم أسلاف العائلات— أولئك الإخوة الستة في كيوتو يقسّمون زيارات أبناء الرعية إلى المعبد. وفي المساء، يجتمعون معاً ويشربون .
بعدما مات جدي ، كان ثمة سؤال مُلحّ حول من سيتولى المهام الكهنوتية في المعبد. تزوج أغلب الأبناء بالفعل ولديهم وظائف. والحقيقة تقال، لم يتوقع أحد موت جدي مبكراً أو هكذا فجأة.
أراد الابن الأكبر— عمي شيماي موراكامي— أن يصبح طبيباً بيطرياً ولكن بعد الحرب عمل في مكتب للضرائب في أوساكا وكان رئيس قسم الفرعي، بينما قام أبي ، الابن الثاني، بتدريس اليابانية في كيو غاكون الإعدادية والثانوية المشتركة في منطقة كنساي. كان الإخوة الآخرين إما معلمون أيضاً، أو يدرسون في كليات البوذية التابعة. ولقد عُرض اثنان من الأخوة للتبني من قِبل عائلات أخرى، إذ يعتبر التبني ممارسة شائعة، و لديهم ألقاب عائلية مختلفة. على أيْ حال، عندما يجلسوا للنقاش حول الوضع لا أحد يتطوع بقبول بمهام المعبد. أن تصبح رئيساً كاهناً في معبد كبير ليس بالأمر السهل أن تتولى ذلك، وعبئاً كبيراً لأي عائلة أحد ما. كان الأخوة يعلمون ذلك جيداً. بالنسبة لجدتي، التي أضحت أرملة، من النوع الصارم الذي لا معنى لها; قد تجد أي زوجة من الصعوبة أن تخدم كزوجة كاهن رئيسي لا يزال معها هناك. كانت أمي الابنة الكبرى لعائلة تجارية راسخة في سينبا، في أوساكا. كانت إمراة تتبع الموضة، فليس كل نوع يناسب كزوجة كاهن رئيسي في كيوتو. ولذلك ليس مستغرباً تشبثها بأبي، بعيون دامعة ، تتوسله بأن لا يتولى زمام الأمور في المعبد.
من وجهة نظري على الأقل ، كأبن له ، تراءى لي بأن أبي شخص بسيط ، و مسؤول . لم يرث من والده ذو ميل صريح ( كان من النوع العصبي للغاية)، ولكنه سهل المراس وطريقته في التحدث تشعر الآخرين بالراحة. كان لديه إيمان صادق أيضاً. ربما قد يكون كاهنا صالحاً ، واعتقد أنه كان يعلم ذلك. تخميني بأنه قد يكون أعزباً و لم يكن ل يقاوم الفكرة كثيراً. ولكن لديه شيء ما لا يمكن مساومته—عائلته الصغيرة.
في النهاية ، ترك عمي شيماي عمله في مكتب الضرائب و خلف جدي ككاهن رئيسي في معبد أنيوجي. و قد خلفه أبنه لاحقاً، وهو أبن عمي جانيوشي. وفقاً ل جانيوشي، وافق شيماي أن يصبح كاهناً رئيسياً فألتزم بدافع من الشعور كأكبر أبنائه. قلت أنه وافق، لكنه كان أكثر من ذلك بحيث أنه ليس له خيار أخر. في ذلك الوقت ، كان أبناء الرعية أكثر تأثيراُ بكثير من الأن، وربما لم يسمحوا له أن ينجوا من فعلته.
عندما كان أبي صبياً ، كان قد أرُسل للتدرب في معبد بمكان ما في نارا. كان المفهوم و المحتمل بأنه سوف تتبناه عائلة كاهن بنارا. غير أنه، عاد إلى المنزل في كيوتو بعد فترة التدريب. كان هذا ظاهرياً بسبب أن البرد أثر سلباً على صحته ، ولكن يبدو أن السبب الرئيسي أنه لم يتأقلم مع البيئة الجديدة. بعد عودته إلى المنزل، عاش كما كان الحال من قبل كأبن لأبويه. ولكن أشعر بأن تجربته ظلت معه ، كما ندبة عاطفية عميقة. لا يمكنني أن أشير إلى أي دليل خاص لهذا ، ولكن كان ثمّة شئ ما عنه جعلني أشهر بتلك الطريقة.
أتذكر الآن تعبير وجه أبي—متفاجئ أولاً، ثم متأثراً، و بعد ذلك أرتاح—مع أن القطة التي من المفترض أننا تخلينا عنها سبقتنا إلى المنزل .
لم أمّر بتجربة أي شئ ٍ مماثل لهذا أبداً. كنتُ قد ترعرّعت— بمحبة إلى حد ما، ذلك ما أود قوله — كطفل وحيد لدى أسرة عادية . وبالتالي لا يمكنني أن أفهم، على مستوى العملي أو العاطفي، ما نوع الندبات الروحية التي قد تُنجم على إهمال طفل من قِبل والديه . بإمكاني أن أتخيل ذلك فقط على مستوى السطحي .
تحدث المخرج الفرنسي فرانكو تروفو عن كونه أجُبر على العيش بعيداُ عن أبويه عندما كان صغيراً. فسعى لبقية حياته عن موضوع الهجر في أفلامه. قد يكون ربما لدى أغلب الناس تجربة محبطة لا يستطيعون أن يعبروا عنها بكلمات ولا يمكنهم أن ينسونها أيضاً.
تخرج أبي من مدرسة هيقاشايما الإعدادية الثانوية ( تعادل مرحلة الثانوية اليوم) في عام 1936م و التحق بمدرسة للدراسات السيزانية بسن الثامنة عشر. كان يتلقى الطلاب بصورة عامة إعفاءاً لمدة أربع سنوات من الخدمة في الجيش، ولكنه نسي أن يعتني ببعض الأوراق الإدارية، و في عام 1938م، عندما بلغ سن العشرون عاماً كان قد جُند. كان خطأً إجرائياً ، ولكن إرتكاب مثل هذا النوع من الأخطاء لا يمكنك بمجرد أن تعتذر أن يُمهد طريقك للخروج منها. فإن البيروقراطية والجيش مثل ذلك. لابدّ من اتباع البروتوكول.
أنتمى أبي إلى فوج المشاة في القرن العشرين، التي كانت جزءاً من الفرقة السادس عشر ( فرقة فوشيمي). تتكون نواة الفرقة السادس عشر من أربع أفواج جنود المشاة : فوج المشاة التاسع (كيوتو) ، وفوج المشاة العشرون (فوكوشياما ) ، وفوج المشاة الثالث والثلاثون (مدينة تيسو، في ولاية ماي)، و فوج المشاة الثامن والثلاثون( نارا). غير واضح لماذا أبي الذي كان من كيوتو ذاتها، قد عُين في فوج المشاة التاسع ولكن عوضاً عن ذلك إلى فوج فوكوشياما البعيدة .
كان هذا على الأقل كيف فهمتها لفترة طويلة ، ولكن عندما نظرت أكثر عمقاً إلى المعلومات الأساسية وجدت بأنني كنت مخطئاً. في الحقيقة، لم ينتمي أبي إلى فوج المشاة العشرون ولكن إلى فوج النقل السادس عشر، التي كانت أيضاً جزءاً من الفرقة السادس عشر. فلم يكن الفوج في فوكوشياما ولكن كان مقرها الرئيسي في فوكاكوسا / فوشيمي ، في مدينة كيوتو. وبالتالي عندما كنت تحت إنطباع حيال إن كان أبي قد أنتمى إلى فوج المشاة العشرون؟ سأناقش هذه النقطة لاحقاً.
كان معروفاً أن فوج المشاة العشرون كونه واحداً من أوائل الواصلين إلى نانجينغ بعد سقوط المدينة . فقد شُوهدت الوحدات العسكرية بشكل عام يافعة ومدنية، غير أن اعطت إجراءات الفوج خاصة سمعة دموية بشكل مفاجئ . كنت أخشى لفترة طويلة بأن أبي قد شارك في الهجوم على نانجينغ، وكنت متردداً في إستقصاء التفاصيل، فقد مات، في أغسطس ، عام 2008م ، وعمره تسعون عاماً، دون أن اسأله أبداً عن ذلك، و دون أن يتحدث عن ذلك أبداً.
وكان أبي قد جُند في شهر أغسطس عام 1938م. بدأت مسيرة فوج المشاة العشرون سيئة السمعة إلى نانجينغ العام الماضي، وذلك شهر ديسمبر عام 1937م، وبالتالي لم يتواجد والدي قرابة عام. عندما علمت بذلك ، شعرتُ بإرتياح كبير، كما لو أن ضغطاً كبيراً ازُيح عني.
صعد أبي على متن سفينة نقل القوات كصف ثاني خاص من فوج النقل السادس عشر، في يوجينا هاربور في الثالث من شهر أكتوبر ، عام 1938م ، ووصل إلى شنغهاي في السادس من أكتوبر. أنضم فوجه إلى فوج المشاة السادس عشر. ووفقاً إلى دليل زمن الحرب، كان قد عُين فوج النقل السادس عشر بالمقام الأول لمهام الدعم والأمن. إذا كنت تتبع تحركات الفوج، سترى بأنها تغطي مسافات لا تصدق لذلك الوقت. كانت الوحدات بالكاد مجهزة بمحركات، و تفتقر للوقود كاف—و كانت الخيول هي وسيلة نقل رئيسية—يجب أن يكون السفر للآن شاقاً للغاية. كانت الحالة في المقدمة رهيباً: لم تتمكن الإمدادات من تصل هناك ; كان ثمّة نقص حاد للمؤونة والذخيرة; كان يبدو الزي الرسمي للجنود بالياً; و قادت الظروف غير صحية إلى تفشي الكوليرا و أمراض معدية أخرى. كان مستحيلاً بالنسبة لليابان ، بقوتها المحدودة، التحكم بدولة ضخمة مثل الصين. كان الجيش الياباني قادراً على السيطرة العسكرية من مدينة تلو الآخرى، إلا أنه من ناحية عملية، غير قادر على احتلال الأقاليم بأكملها. فقد كُتبت المذكرات من قبل جنود فوج المشاة العشرون و اعطت صورة واضحة كيف كان الوضع البائس. لم تكن قوات النقل تشارك في الخطوط الأمامية للمعركة عادة بصورة مباشرة، ولكن هذا لا يعني بأنهم كانوا آمنين. كما كانوا مسلحين تسليحاً خفيفاً فقط (عادة يحملون سلاحاً قديماً مجرد حربة )، عندما هاجم العدو من الخلف عانوا من إصابات كبيرة .
هكذا بعد إنطلاق مدرسة سيزان ، فقد اكتشف أبي متعة الهايكو وانضمامه إلى دائرة الهايكو. كان منسجماً معها ، للأستخدام مصطلحاً حديثاً . كتب العديد من شعر الهايكو عندما كان جندياً ونشرت في صحيفة مدرسة الهايكو; على الأرجح ارسلها بالبريد إلى المدرسة من الجبهة :
الطيور المهاجرة
آه – إلى حيث يتجهون
يجب أن يكون وطني
جندي ، لكنه كاهناً
أشبك يدي متضرعاً
نحو القمر
لست خبيراً في شعر الهايكو، وبالتالي هذا يجعلني أن أقول كيف أنجز شعره . من الواضح، ما يُجمع تلك القصائد معاً ليس تقنياً بل المشاعر الصريحة والصادقة التي تؤكدها.
ولقد درس أبي، بأمانة دون شك، كي يصبح كاهناً. ولكن خطأ كهنوتي حوله إلى جندي. تعرض إلى تدريب أساسي صارم، وقد أعُطي بندقية نوع 38 ، و وضع في سفينة نقل القوات، و ارُسل إلى معارك مخيفة في الجبهة. كانت وحدته في تحرك بشكل متواصل، واشتبكت مع القوات الصينية و المسلحين مشكلين مقاومة عنيفة. في كل طريقة ممكن أن تتخيلها، كان هذا نقيض للحياة في المعبد السلمي في تلال كيوتو. لابدّ أن يكون قد عانى من إرتباك عقلي هائل و اضطراب روحي. في خضم كل ذلك، قد تكون كتابة شعر الهايكو عزاؤه الوحيد. قد تكون الأشياء التي لا يستطيع كتابتها في رسائله، أو قد لا تتمكن من عبر الرقابة، يضع نموذج الهايكو—معبراً عن نفسه في شفرة رمزية، كما كانت—حيث يمكنه الكشف على مشاعره الحقيقية و الصادقة .
لم يتحدث إليّ أبي ذات عن الحرب سوى مرة واحدة. عندما قال لي كيف أن وحدته العسكرية قامت بإعدام جندي صيني أسير. لا أعلم ما الذي دفعه لإخباري بذلك. لقد حدث ذلك منذ فترة طويلة لدرجة أن ذاكرته ذاكرة معزولة، فالسياق ليس واضحاً. كنت لازلت في الصفوف الدنيا في المدرسة الإبتدائية. ارتبط بواقع الأمر كيف قد حدث الإعدام. بالرغم أن الجندي الصيني يعلم بأنه سوف يُقتل، لم يُقاوم ، ولم يُظهر أي خوف، بل مكث هناك هادئاً بعينين مغلقتين. كان مقطوع الرأس. أخبرني أبي بذلك بأن سلوك الرجل كان مثالياً. بدا بأن لديه مشاعر عميقة بإحترام الجندي الصيني. لا أعلم إن كان قد شاهد كما الجنود الأخرون في وحدته العسكرية تنفيذ الإعدام، أو كان قد أجُبر أن يضطلع بنفسه بدور مباشر. ليس ثمّة طريقة الآن لتقرر ما إذا هذا يرجع إلى ذاكرتي الضبابية، أو ما إذا وصف أبي الحادثة بعبارات غامضة متعمداً. ولكن هناك شئ واحد واضح: تركت التجربة مشاعر كرب وعذاب بحيث بقيت لفترة طويلة في روح ذلك الكاهن الذي تحول إلى جندي.
في الوقت، لم يكن شائعاً على الإطلاق أن يُسمح للجنود و المتطوعون الجدد أن يمارسوا القتل من خلال إعدام الجنود الصينيين الأسرى. كان قتل السجناء العزل، بالطبع، إنتهاك للقانون الدولي، ولكن أظهر الجيش الياباني في تلك الفترة بأخذ ممارسة القتل من المسلمات. فمن المحتمل ألا تملك وحدات الجيش الياباني الموارد اللازمة لرعاية السجناء. لقد نُفذ قتل أغلب أولئك المعدومين إما بإطلاق النار على السجين أو طعنه بالحربة، ولكن أتذكر أبي يخبرني بأن هذا الإعدام بالذات قد اسُتخدم سيفاً .
لا داعي للقول، بأن حكي أبي عن ذبح الرجل بدم بارد بالسيف بات محفوراً في دماغي الشاب. بعبارة أخرى، كابد أبي هذا الحمل الثقيل— الصدمة، بمصطلح اليوم—أنتقل، جزئياً، إليّ ، أبنه. تلك الكيفية التي تعمل بها العلاقات الإنسانية، و كيف يعمل التاريخ. كان فعلُ الإنتقال و الطقوس. كان أبي بالكاد يتحدث كلمة عن تجربته في فترة الحرب. من غير المرجح أنه أراد أن يتذكر هذا الإعدام أو يتحدث عنه. مع ذلك لابدّ أنه قد شعر بحاجة ملحة بأن يربط القصة بأبنه الذي من لحمه ودمه، حتى لو يعني أن ذلك سيبقى جرحاً غائراً لكلينا.
عاد فوج المشاة العشرون، بجانب وحدة أبي العسكرية إلى اليابان في أغسطس عام 1939م. استأنف أبي دراسته بمدرسة سيزان بعد مرور سنة كجندي. في ذلك الوقت، كان يعني التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية خدمة عامان، ولكن لسبب ما خدم أبي عام ٍ واحدٍ فقط . ربما أخذ الجيش بالحسبان حقيقة بأن قد يكون ادُرج أسم أبي كطالب عندما تم تجنيده.
واصل أبي بعد خدمته العسكرية كتابة شعر الهايكو بحماس. كان قد كتَب هذا الشعر في أكتوبر 1940م، ربما كانت مستوحاة من زيارة ودية من قِبل شباب هتلر إلى اليابان :
كانوا يلحنون بصوت ندي ، ويغنون
كي يُغري الغزلان قرباً،
إلى … شباب هتلر
شخصياً ، أحب حقاً شعر الهايكو هذا ، حيث تلتقط لحظة غامضة في التاريخ بطريقة بارعة ، و إستثنائية . ثمة تباين لافت للنظر بين الصراع الدموي البعيد في أوروبا و الغزلان (ربما الغزلان الذائعة الصيت في نارا). أستمتع أولئك من منظمة شباب هتلر في زيارتهم القصيرة إلى اليابان، ربما قد ذهبوا كي يهلكوا في شتاءات مريرة بالجبهة الشرقية.
تستهويني هذه القصيدة أيضاً :
تلك هي ذكرى سنوية
لموت عيسى، جلست هنا
مع قصائده الحزينة
يصف العالم بأنه كان هادئاً و مطمئناً، ومع ذلك، ثمّة إحساس دائم بالفوضى .
كان أبي يحب الأدب دائماً، وبعدما اصبح معلماً، يقضي الكثير من وقته في القراءة. كان البيت ملئ بالكتب. ربما هذا قد أثّر خلال فترة مراهقتي، عندما نَميت شغف القراءة لنفسي. تخرج أبي بمرتبة الشرف من مدرسة سيزان، و في مارس عام 1941م ، التحق بقسم الأدب بجامعة كيوتو الإمبراطورية. لا يمكن تجاوز اختبار القبول بسهولة بالنسبة لمدرسة عليا مثل جامعة كيوتو الإمبراطورية بعدما خضع لتعليم بوذي لكي يصبح كاهناً. كثيراً ما تقول لي أمي ‘‘والدك ذكي جداً.’’ كيف كان ذكياً حقاً ليس لدي أيْ فكرة. بصراحة ، أنه ليس ذلك السؤال الذي يُثير إهتمامي كثيراً. لشخص ما في مجال عملي، الذكاء أقل أهمية من الحدس الحاد. أن تكون ذلك ، أيّا كان الأمر، تبقى الحقيقة بأن أبي كان يتلقى دوماً درجات ممتازة في المدرسة.
بالمقارنة به ، لم يكن لدى اهتمام كبير بالدراسة أبدا; و كانت درجاتي باهتة من البداية إلى النهاية. أنا من النوع الذي يسعى بلهفة بالأشياء التي اهتم بها ولكن لا يمكنني أن أنزعج بأي شئ أخر. كان ذلك ما ينطبق عني بصدق وكذلك عندما كنت طالباً، ومازال ذلك صحيحاً الآن.
أصيب أبي بخيبة أمل لهذا، ومتأكد بأنه كان يقارنني بنفسه في نفس السن. ولدت في زمن السلام، لابّد أن يكون قد فكر بذلك. بإمكانك أن تدرس كيفما يحلو لك، دون أن يقف شيء في طريقك. و بالتالي لماذا لا يمكنك أن تبذل المزيد من الجهد؟ أعتقد بأنه أراد مني أن أتبع مسار لم يتمكن هو أن يتبعه بسبب الحرب.
ولكني لم أستطع أن أرتقي إلى مستوى توقعات أبي. إذ لم أتمكن ابدأ أن أدرس بالطريقة التي أرادني بها. وجدت أغلب الصفوف في المدرسة غير مستلهمة، النظام المدرسي مفرط في إرتداء الزي وقمعي. وقاد هذا أبي إلى الشعور بفزع مزمن ، و شعرت بحزن مزمن( وبقدر معين من الغضب اللا واعي). عندما ظهرت لأول مرة كروائي، بعمر الثلاثين عاماً، كان أبي مسروراً للغاية، ولكن في ذلك الوقت قد نَمتْ علاقتنا الفاترة و البعيدة.
حتى الآن أحمل معي هذا الشعور— أو ربما رواسب منها — خيبت ظن أبي، خذلته. في العودة إلى سنوات المراهقة، فتلك جعلت الأشياء تبدو غير مريحة في المنزل، حيث تيار ثابت بالشعور بالذنب من جانبي. مازلت أمر بكوابيس عن أدائي لإختبار مدرسي ولم أستطع إجابة عن سؤال واحد. يمضي الوقت دون أن أفعل شيئاً، بالرغم أنني واعٍ لرسوبي في الإختبار سوف تكون هناك عواقب وخيمة—وهذا نوع من الحلم. أستيقظ عادة و جسدي يتصبب عرقاً بارداً.
غير أن، في ذلك الوقت، أن أكون ملتصقاً بطاولتي، أنهي واجباتي المدرسية، واحصل على درجات أفضل في الاختبارات فهي أقل جاذبية من قراءة الكتب التي استمتعت بها، والإستماع إلى الموسيقى التي أحببتها، ولعب الرياضات أو لعب **ماه جونغ مع أصدقائي، والذهاب إلى مواعيد غرامية مع الفتيات.
كل ما يمكننا فعله هو تنفس الهواء في اللحظة التي نعيشها، و نحمل معنا أعباء الوقت الخاصة، ونكبر مع تلك القيود. هكذا تسير الأمور.
تخرج أبي من مدرسة سيزان للدراسات بفصل الربيع عام 1941م، وتلقى في نهاية سبتمبر مسودة التجنيد الخاصة. ففي الثالث من أكتوبر، عاد إلى إرتداء الزي الرسمي، أولاً في فوج المشاة العشرون(فوكوشيما)، ومن ثم فوج النقل الثالث والخمسون، الذي كان جزءاً من الفرقة الثالث والخمسون.
ولقد تمركز جنود الفرقة السادس عشر بصورة دائمة في منشوريا في عام 1940م و بينما انتظمت الفرقة الثالث والخمسون لكي تحل محله. على الأرجح، يُفسرالإرتباك بإعادة التنظيم المفاجئ لماذا وضع أبي مبدئياً في فوج فوكوشيما (كما قلت، كنت دوماً مقتنعاً بشكل خاطئ بأنه قد كان في فوج فوكوشيما من المرة الأولى التي قد جُند فيها.) أرسل الفرقة الثالث والخمسون إلى بورما عام 1944م، وكان ذلك في معركة إمفال، من ديسمبر إلى مارس ، 1945م، حيث كانت الفرقة قد أهُلكت تقريباً من قِبل بريطانيا في معركة نهر ايراوادي.
غير أن و بصورة متوقعة تماماً، في 30 نوفمبر عام 1941م، أطُلق سراح أبي من خدمة العسكرية وسُمح له أن يعود إلى الحياة المدنية. كان في 30 نوفمبر قبل ثمانية أيام من الهجوم على بيرل هاربر. بُعيد ذلك الهجوم، أشك بأن الجيش قد كان سخياً بشكل كافي لتركه يغادر.
كما قالها أبي، أنقذ حياته من قِبل ضابط . كانت رتبة أبي جندي الدرجة الأولى. أستدعى في ذلك الوقت من قبل ضابط كبير، والذي قال له ،‘‘ أنت تدرس بجامعة كيوتو الإمبراطورية، وأن تخدم بلدك بشكل أفضل من خلال مواصلة دراستك بدلاً من أن تكون جندياً.’’ هل كان لدى الضابط سُلطة أن يتخذ هذا القرار؟ ليس لدي أيْ فكرة. أنه من الصعوبة تصور بأن طالب العلوم الإنسانية مثل أبي يمكن أن يرى كما بطريقة ما أن يخدم البلد من خلال العودة إلى الكلية و يدرس الهايكو. كان ثمّة عوامل أخرى في العمل. في تلك الحالتين، أعفى من الجيش وأضحى رجلاً حراً مرة أخرى.
على الأقل هذه كانت قصة سمعتها ، أو لدي ذاكرة سمعية، كطفل. و لسوء الحظ، لم تنسجم مع الحقائق. يُشير أرشيف جامعة كيوتو الإمبراطورية بأن أبي كان مسجلاً في قسم الأدب في شهر أكتوبر عام 1944م. ربما ذاكرتي غير واضحة. أو ربما كانت أمي هي من قالت لي هذه القصة، أو ذكرتها مشوشة. والأن ليس ثمّة طريقة للتحقق من ما هو حقيقي و غير حقيقي.
وفقاُ إلى الأرشيف ، دخل أبي قسم الأدب بجامعة كيوتو الإمبراطورية في شهر أكتوبر عام 1944م، وتخرج في شهر سبتمبر عام1947م. ولكن ليس لدي فكرة أين كان هو، أو ماذا كان يعمل ، خلال سنوات عمره ما بين ثلاث وعشرون إلى ستة وعشرون، بعد ثلاث سنوات من إعفائه من الجيش وقبل دخوله جامعة كيوتو الأمبراطورية.
بعدما أعفى أبي من الخدمة العسكرية، اندلعت الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ. في أثناء الحرب ، أبُيدت الفرقة السادس عشر والفرقة الثالثة والخمسون بشكل أساسي. لو لم يُعفى أبي ، و لو كان قد نُقل مع إحدى وحداته السابقة، فقد يكون بدون شك مات على الأغلب في ساحة المعركة، ومن ثم ، بالطبع لم أكن حياً الآن. يمكنك أن تطلق عليها حظاً، غير أن ينقذ حياته بينما رفاقه السابقين يقضون نحبهم أضحى مصدراً للإلم ٍ وكربٍ عظيم. أفهم أكثر من ذلك الآن سبب إغلاقه عينيه ويتلو سوترا بصدق كل صباح من حياته.
في 12 يونيو عام 1945م، بعد أن كان قد دخل جامعة كيوتو الإمبراطورية، تلقى أبي مسودة التجنيد الثالث. و كان قد عُين في هذا الوقت إلى إقليم تشوبو فيلق 143 كجندي من الدرجة الأولى. كان غير واضحاً مكان تمركز الفيلق، ولكنها بقيت في اليابان. بعد شهرين ، في الخامس عشر من شهر أغسطس، أنتهى الحرب، و في ثمانية وعشرون من شهر أكتوبر كان أبي قد أعُفي من الخدمة وعاد إلى الجامعة. كان يبلغ من العمر سبعة وعشرون عاماً.
أجتاز أبي في شهر سبتمبر عام 1947م، الإمتحانات وتلقى درجة الليسانس. واصل برنامج التخرج في الأدب بجامعة كيوتو الإمبراطورية. ولدت في شهر يناير عام 1949م. توقف أبي عن دراساته قبل إنهاء البرنامج ، ليس بسبب سنه وإنما الحقيقة بأنه كان متزوجاً ولديه طفلاً. ومن أجل أن لقمة العيش، عمل كمدرس للغة اليابانية بمدرسة كيوي غاكيون، نيشنوميا ، لا أعرف عن تفاصيل كيفية تزوج أبي و أمي. بما أنهم كانوا يقيمون متباعدين—واحد في كيوتو ، و الآخر في أوساكا—على الأرجح أن يكون قد قدمهم للبعض أحد معارفهم المتبادلة. وقد كانت أمي تنوي أن تتزوج رجلاً آخر، معلم موسيقى، ولكنه مات في الحرب. و أحترق المتجر الذي كان يملكه والدها، في سنبا، أوساكا، بغارة جوية أمريكية. وكانت تتذكر دوماً قصف حاملة الطائرات غرومان على المدينة، وتهرب للنجاة بحياتها عبر شوارع أوساكا. ولقد كان الحرب له تأثير بالغ على حياة أمي أيضاً.
كانت أمي ، التي تبلغ من العمر ستة وتسعون عاماً، معلمة للغة اليابانية أيضاً. بعد التخرج من قسم الأدب بمدرسة شوين للنساء ، في مدينة أوساكا، عملت كمعلمة بمدرسة التي ارتادتها، ولكنها تركت العمل عندما تزوجت.
وفقاًً إلى أمي، عاش أبي في شبابه حياة جامحة جداً. كانت تجاربه خلال فترة الحرب حديثة العهد، وخيبات أمله عن حقيقة حياته التي لم تسَر كما أراد جعلت الأمور تسير بصعوبة أحياناً. كان يشرب كثيراً، و ويضرب طلبته أحيانا. ولكن مع مرور الوقت كنت أشب عن الطوق وكان ثملاً بعض الشئ إلى حد كبير. وقد يكون محبطاً و متعكر المزاج أحياناً، ويشرب كثيراً(كانت تشتكي أمي بشأن ذلك كثيراً)، ولكن لا أذكر أي التجارب المزعجة بحق منزلنا.
أعتقد بأن أبي كان معلماً جيداً للغاية. عندما مات، كنت متفاجئاً بعدد طلبته السابقين الذين أتوا ليقدموا احترامهم. بدوا بأنهم يكنون له قدراً كبيراً من المودة. بات العديد منهم أطباء، واهتموا به جيداً كما حارب السرطان مرض السكري.
كانت أمي على مايبدو معلمة رائعة في حد ذاتها، وحتى بعدما أنجبتني وباتت ربة منزل بدوام كامل و قد يقف العديد من تلاميذها عند المنزل. لأسباب عدة، على الرغم من، لم أشعر أبداً بأنني كنت قد توقفت فجأة عن أصبح معلماً.
كما تقدمت بالسن وتشكلت شخصيتي، بات النزاع النفسي بيني وبين أبي أكثر وضوحاً. لم يكن كلانا يتزعزع، وعندما يحين التعبير عن أفكارنا بصورة مباشرة ، كنا أثنان من هذا النوع. للأفضل أو للأسوء.
بعد أن تزوجت وبدأت العمل، زدنا أنا و أبي أكثر بعداً . و عندما بت كاتباً بدوام كامل أضحت علاقتنا معقدة وفي النهاية قطعنا جميع اتصالاتنا تقريباً. لم يرى أحدنا للآخر أكثر من عشرين عاماً، و كنا نتحدث عندما يكون هناك شئ هام.
ولدنا أنا و أبي في أزمنة وبيئات مختلفة، و كانت طريقة تفكيرنا ونظرتنا إلى العالم تبعد أميالاً . إذا كانت هناك فكرة محددة كنت سأحاول على أثرها أن أعيد علاقتنا، ربما آلت الأمور إلى منحى آخر، ولكنني كنتُ أركز بشدة على ما أردت أن أفعله لبذل مجهود.
تحدثنا أنا و أبي أخيراً وجهاً لوجه قبل وفاته بفترة وجيزة . كنتُ بعمر الستين تقريباً، و أبي بالتسعين عاماً. كان يمكث في مستشفى بمنطقة نشيجن، بمدينة كيوتو. كان يعاني من مرض السكر بشكل فظيع، واجتاح السرطان معظم جسده. بالرغم من أنه كان دوماً قوي الجانب، إلا أنه بدا هزيلاً. بالكاد تعرفت عليه. و هناك، في الأيام الخير من حياته— خلال أيام أحتضاره—تحدثنا أنا و أبي محادثة غريبة وتوصلنا إلى نوع من المصالحة. على الرغم من خلافاتنا، وبالنظر إلى أبي الهزيل شعرتُ بوجود رابط بيننا.
حتى الآن، يمكنني أن أسترجع ذلك الإرتباك المشترك في أيام الصيف عندما قُدنا معاً دراجته على الشاطئ الكوري للتخلي عن القطة، تلك القطة التي تغلبت علينا كلياً. يمكنني أن أتذكر صوت الأمواج، و عبير صفير الريح عبر أشجار الصنوبر. فإن تراكم أشياء تافهة مثل هذه صقلتني إلى الشخص الذي هو أنا.
لدي المزيد من الذكرى التي تتضمن قطة. أدرجت هذه الحادثة في إحدى رواياتي ولكن قد نتطرق لها هنا مرة أخرى، كشئ حدث بالفعل.
لقد كان لدينا هرة صغيرة بيضاء. لا يسعني أن أذكر كيف أقتنيناها ، لابدّ أننا كان لدينا دوماً قطط في ذلك الوقت تأتي إلى منزلنا. ولكنني أتذكر كم كان فرو تلك القطة جميلاً ، وكم كانت رائعة .
في إحدى المساءات، كنت أجلس على الشرفة، تركض هذه القطة فجأة مباشرة إلى أعلى شجرة الصنوبر الرفيعة في حديقتنا. على الأغلب كما لو أرادت أن تظهر لي كم كانت هي شجاعة و رشيقة. لم أستطع التصديق كم ركضت برشاقة أعلى الجذع و أختفت إلى داخل الفروع العليا. بعد لحظة، بدأت القطة تصدر موءاً بشكل يدعو للرثاء، مع أنها كانت تتوسل للمساعدة. لم يكن لديها مشكلة التسلق عالياً جداً، ولكن بدأ مخيفاً العودة إلى الأسفل.
وقفت أسفل الشجرة أبحث، ولكنني لم أتمكن من رؤية القطة. بإمكاني أن أسمع صرختها الخافتة. ذهبت إلى أبي وأخبرته بماحصل، متمنياً بأنه قد يمكنه أن يبحث عن طريقة لإنقاذ القطة. ولكن لم يكن ثمّة شيء يمكن أن يفعله; كان مرتفعاً جداً بحيث لا فائدة من السلم. واصلت القطة موائها للنجدة، وكما بدأت الشمس بالمغيب. وغطى الظلام أخيراً شجرة الصنوبر.
لا أعلم ما الذي حصل لتلك اللقطة الصغيرة. عندما أستيقظت في الصباح اليوم التالي، لم اتمكن من سماع صرختها مرة أخرى. وقفت أسفل الشجرة و ناديت القطة بإسمها، ولكن لم يكن ثمّة رد. الصمت المخيم فحسب.
ربما في بعض الأحيان قد تنزل القطة خلال الليل وتغادر في مكان ما(ولكن إلى أين؟). أو ربما، ليس بإمكانها أن تنزل، وقد تتشبث بالفروع، وتشعر بالإرهاق، تصبح أضعف وأضعف حتى تموت. مكثت على الشرفة، محدقاً بالشجرة، مع تلك سيناريوهات التي تدور في بالي. أفكر في تلك القطة الصغيرة تتشبث بحياتها الغالية بمخالبها الصغيرة، ومن ثم تذبل وتموت.
علمتني التجربة على درساً حياً : بأن البناء أكثر صعوبة من الهدم. للتعميم من هذه، ربما تقول بأن النتائج تطغى الأسباب و تضعفها. في بعض الحالات، تُقتل قطة في عملية; وفي حالات أخرى، إنسان كذلك.
على أي حال ، ثمة شئ واحد فقط أردت أن أوضحها هنا. حقيقة واحدة، واضحة:
أنا أبن عادي للرجل عادي.أعلم ذلك، بأنه يبدو بديهياً جداً، بما أن بدأت أن أنقب عن تلك الحقيقة، بات من الواضح لي بأن كل شئ قد حدث في حياة أبي وحياتي كان عرضياً. نعيش حياتنا بهذه الطريقة: نشاهد أشياء تأتي عن طريق حادثة و صدفة محضة كحقيقة الوحيدة ممكنة.
بعبارة أخرى، نتخيل سقوط قطرات المطر على أرض بإمتدادها الواسع. كل واحدٍ منا هو قطرة مجهولة بين عدد لا يحصى من القطرات. قطرة منفصلة، و فردية، بالطبع ، غير أن واحدة قابلة للإستبدال. ومع ذلك، و للقطرات المعزولة إحساسها الخاص، وتاريخها الخاص، و مهمتها الخاصة لحمل ذلك التاريخ. حتى إذا خسرت تكاملها المتفرد و تستوعب داخل شئ مشترك. أو ربما على وجه التحديد لأنها مستوعبة إلى وجود أكبر، و مشترك.
يعيد بي عقلي إلى الماضي بين حين وآخر إلى شجرة الصنوبر التي تلوح بالأفق في حديقة منزلنا ب شوكوغاوا، وإلى تفكير بتلك القطة الصغيرة، وهي لا تزال متشبثة بالفرع، وجسدها يتحول إلى عظام مندثر. أفكر بالموت، وكم هو صعب أن تهبط عائداُ إلى الأرض، والنظر إلى الأسفل بعمق للغاية ما يجعل رأسك يعاني من الدوران.
https://www.newyorker.com/magazine/2019/10/07/abandoning-a-cat
*
يعد مهرجان Obon أحد أكبر وأهم الأحداث الدينية في اليابان. هذا تقليد بوذي يكرّم أرواح أسلافه ، ولهذا السبب يُعرف أيضًا باسم مهرجان الموتى أو عيد النفوس.
**
ماه جونغ هي لعبة صينية تشبه الدومينو، تم إدخالها إلى الغرب في سنوات العشرينيات.