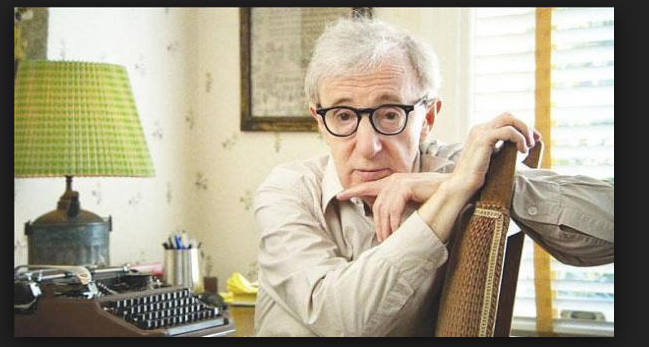البُعد التأملي جزء أساس في عمل الكاتب الأميركي بول أوستر، ووسيلة لقول نفسه من خلال نصٍّ كامل أو شذرات متفرّقة تتنقل من كتاب إلى آخر وتشكّل مجتمعةً حالاً من القراءة المتجددة للذات. تأمّلٌ بدأه في «أختراع العزلة» (1982) وتابعه في «يوميات شتائية» (2012) و»نزهات في الفضاء الداخلي» (2013)، وهي نصوص – مرايا سرد فيها اختبارات مؤسسة من سنّي الطفولة والمراهقة قادته إلى ما هو عليه اليوم.
«غليوم أوبِّن»، الذي صدر حديثاً عن دار «أكت سود» الباريسية، يندرج في هذا السياق، علماً أن هذا الكتاب لم ينجزه أوستر، وبالتالي لا وجود له في الإنكليزية لكونه يتألف من 14 نصاً أخذت الدار المذكورة بنفسها مبادرة جَمْعِها، وتتراوح بين بحوث ومداخلات ومقدّمات وحوارات صدرت في مجلات أميركية وفرنسية مختلفة، ويحيّي الكاتب فيها مجموعة من المبدعين الذين لعب لقاؤه بهم أو بأعمالهم دوراً حاسماً في مساره ككاتب. مبدعون أميركيون مثل ناتاناييل هاثورن وإدغار ألان بو وجورج أوبّن وجو برينارد وجيم جارموش، وأيضاً فرنسيون مثل جورج بيريك وألان روب غريّيه وجاك دوبان وأندريه دو بوشي، من دون أن ننسى الإرلندي صامويل بيكيت.
تحيات يوجّهها أوستر في كل مرة لواحد من هؤلاء من خلال توقفٍ عند تفصيل أو مجموعة تفاصيل صغيرة ومثيرة في حياته أو عمله قادرة على قول حقيقته، وأيضاً بعضٍ من حقيقة أوستر بالذات. فمن الشاعر الأميركي أوبِّن، الذي كان صديقاً حميماً للكاتب، يستحضر الأخير لقاءه الأول به، وتحديداً الحالة التي فتح أوبِّن فيها باب منزله له لأول مرة، إذ «كان يرتدي قفّازين من كاوتشوك زهري تعلوهما رغوة الصابون» لأنه كان يغسل الأواني. وضعية متواضعة تبعد كل البعد من «تلك التي ننتظرها عادةً من شاعر كبير لطالما أثار إعجابنا».
والمفاجأة ذاتها كانت في انتظار أوستر لدى لقائه للمرة الأولى مع روب غريّيه خلال برنامج أدبي. فبدلاً من الكاتب البولشفي المعروف بقسوته وعنف مداخلاته، تعرّف أوستر إلى إنسان حار ولطيف أضحكه بحسّه الفكاهي العالي طوال السهرة التي أمضاها معه بعد البرنامج، وإلى روائي شغوف مثله بالفن السابع.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى دو بوشي الذي لم يعرف أوستر فيه، طوال فترة علاقتهما في باريس، ذلك الرجل القاسي والبارد والصعب، كما يصوّره كثيرون، بل شاعراً في غاية اللطف منحه صداقته فوراً ومن دون مقابل، على رغم اختلاف عمريهما، وتناقش معه بصراحة في كل المواضيع التي تهمّه خلال نزهات طويلة في شوارع باريس، وكان وراء اكتشاف أوستر كتّاباً وشعراء كثراً تأثّر بهم، مثل بول سيلان والشعراء الروس ولورا ريدينغ وجيمس ميريل.
وفي ما يتعلّق بالشاعر دوبان الذي ربطته به علاقة صداقة حميمة خلال إقامته في فرنسا، وترجم بعض قصائده إلى الإنجليزية، يستحضر أوستر خصوصاً كرم الشاعر الكبير تجاهه الذي تجسّد بفتحه أبواباً كثيرة له في باريس وبابتكاره مشاريع خيالية فقط لمساعدته مادياً، وبإيوائه في منزله حين كان في أمسّ الحاجة إلى ذلك.
وبينما نستخلص من النص الذي نقرأه في الكتاب حول إدغار ألان بو صورة لهذا العملاق تختلف كلياً عن الكليشيه المتداول حوله كـ «كاتب فرنسي كتب باللغة الإنكليزية»، صورة يظهر فيها كرائد الأدب الأميركي المستقل، مثل والت ويتمان، يلخّص نص «بطاقات بريدية إلى جورج بيريك» بطريقة دقيقة جوهر فن هذا الكاتب الذي يجمع بطريقة نادرة بين «براءة وامتلاء». ويقصد أوستر بـ «البراءة» تلك النقاوة المطلقة في النيات، وبـ «الامتلاء» ذلك الإيمان الكلي بالمخيّلة.
ومن مواطنه، الفنان التشكيلي جو برينارد الذي خطفه مرض الإيدز عام 1994، يستحضر أوستر عمله الأدبي الفذّ «أتذكّر» الذي أوحى إلى بيريك بالكتاب الذي يحمل العنوان نفسه، واستعان برينارد لكتابته بصيغة سحرية تتكرر على طول النص وتسمح لجميع قرّائه بالتماثل به. كتاب يسرّ أوستر لنا بأنه قرأه مرات عديدة، وفي كل مرة منحه الانطباع بـ «نصٍّ جديد وغريب ومدهش يتعذّر استهلاكه».
وفي نهاية الكتاب، نطالع نصّاً لصاحب «ثلاثية نيويورك» رصده للقاء جمعه بصامويل بيكيت في مقهى «كلوزري دي ليلا» الشهير في باريس، وبدا فيه هذا العملاق مرتبكاً ومشكّكاً بقيمة بعض نصوصه، وخصوصاً بروايته «ميرسييه وكامييه»، قبل أن يقول له بلهجته الإرلندية الرقيقة، بعد أن حاول عبثاً لفت انتباه النادل: «لا نظرة في العالم يصعب الإمساك بها أكثر من نظرة النادل».
يبقى أن نشير إلى أن أهمية هذا الكتاب لا تكمن فقط في الشهادات القيّمة والشخصية التي يمنحنا أوستر إياها حول الوجوه الأدبية والفنية المذكورة، ومن خلال ذلك، حول السلطة الموحّدة للفن، بل أيضاً في تلك الصفحات المنيرة التي يتحدث فيها عن علاقته الشخصية بالأدب وعمله ككاتب وشغفه بسيرورة الكتابة وليس فقط بنتيجتها، وبالتالي بأهمية الطريقة التي يكتب فيها وركائزها، أي الدفاتر التي تعلو صفحاتها مربّعات صغيرة ويعتبرها «بيوتاً للكلمات وأمكنة سرّية للفكر وتحليل الذات»، وخصوصاً قلم الحبر أو الرصاص الذي يرى فيه «أداةً بدائية تمنح الانطباع بأن الكلمات تخرج من جسدنا فنرصّع بها الصفحة».
تكمن قيمة الكتاب أيضاً في الرسالة التي يسيّرها أوستر في كل نصوصه، ومفادها بأنه، على رغم التدمير الذي يلحق بالثقافة على يد صناعة الترفيه واللهو، ستبقى دائماً تلك الحاجة إلى القصص، إلى الكلمات، لدى البشر: «لا قيمة للأرقام حين يتعلق الأمر بالكتب، يقول الكاتب في أحد هذه النصوص».